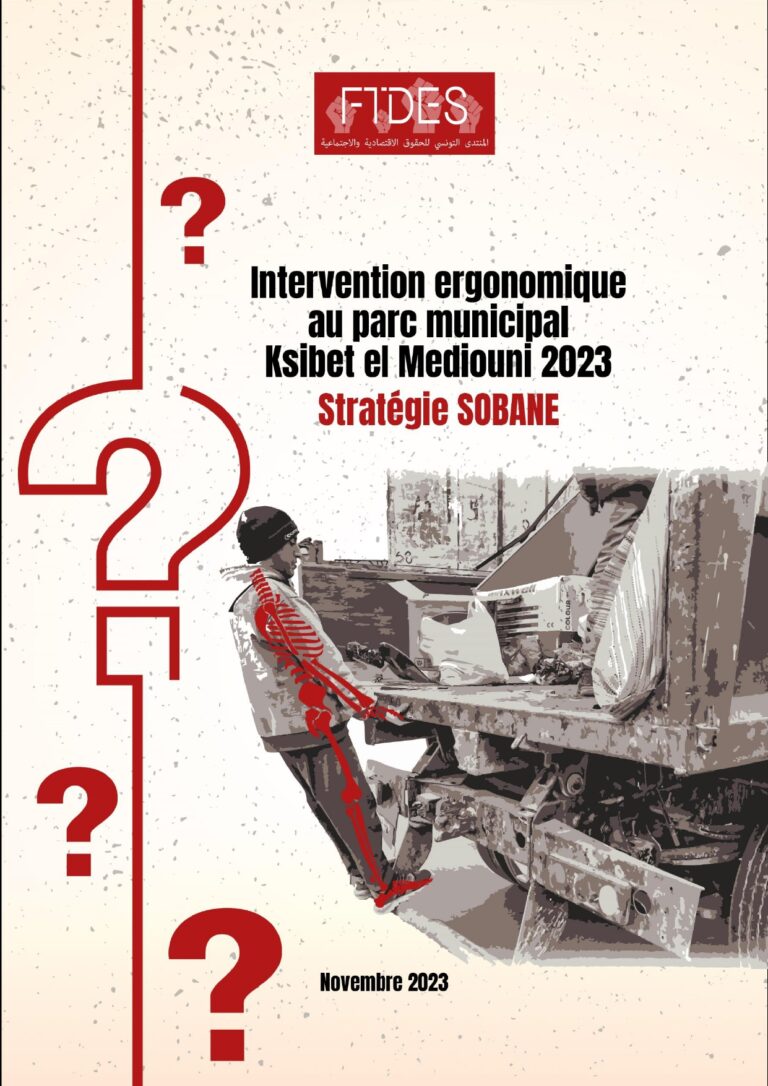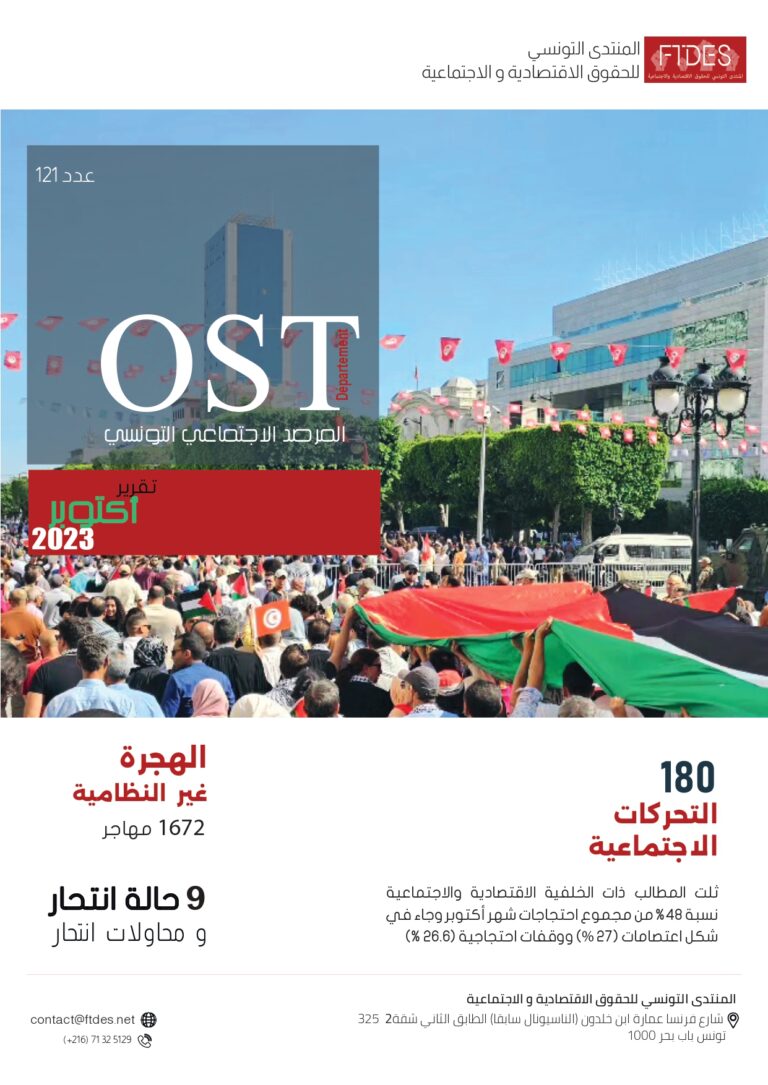السياحة البيئية في طبرقة: وجه من وجوه التضامن النسوي المُتحدي للتغيرات المناخية
مالك الزغدودي: صحفي وباحث تونسي مهتم بقضايا البيئة وحقوق الإنسان
تعد مدينة طبرقة واحدة من الوجهات السياحية التي تتميز بثنائية الغابة والبحر، حيث يتلاقى جمال الطبيعة بالخصوصيات الثقافية المُميزة لسكان جبال خمير.
بدأ بعض سكان المدينة في السنوات الأخيرة، بتقديم خدمات سياحية تجمع ما بين توفير زيارات الى الغابات أو البحر، واكتشاف الخصوصيات الغذائية والتُراثية المميزة للمنطقة، حيث أصبحت المدينة من الجهات الجاذبة لمُحبي السياحة البيئية.
من بين هذه المشاريع التي مزجت بين المحافظة على النظام البيئي المحلي وفي نفس الوقع خلقت موارد اقتصادية دائمة لسكان المنطقة نال مطعم “بِيرْ نَاتِيرْ” Pure nature” رواجا كبيرا بين محبي خوض تجارب ثقافية غذائية تقليدية وعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية أو البحرية والباحثين عن المناظر الطبيعية الجميلة.
تبرز أيضا خصوصية هذا المكان في تلاحم النساء، اللاتي يعملن فيه بتفانٍ على تطوير طرق الطبة المحلية والتعريف بها، حيث يتجسد التضامن بين النساء كقيمة أساسية لهذا المشروع.
مشروع شخصي يتحول إلى حلم جماعي
في قلب هذه الوجهة السياحية البيئية، تجتمع النساء العاملات ضمن هذا المشروع، ليس فقط لطبخ أطباق تعكس تراث المنطقة أو تجسد جانبا مهما من التراث اللامادي لا فقط لمنطقة خمير بل للشمال والوسط الغربي التونسي مثل أنواع الخبز المختلفة مثل الطابونة /الملاوي /الخبز المبسس /خبز الكانون، بل ليُشكلنَ صورة حية للتعاون والتضامن بين النساء ومثالا عن نجاح المشاريع التي تحترم البيئة وحقوق المرأة. حيث أكدت دلندة صاحبة فكرة مشروع “pure nature” أن فكرة تأسيس فضاء سياحي بيئي يعرف بتاريخ المنطقة وتراثها المادي واللامادي وتقديم أطباق تقليدية تعكس الثراء الغذائي للمنطقة، مع التأكيد على أن الفضاء مساحة للتعاون وتبادُل الأفكار بين كل العاملات والعاملين فيه وهو مشروع لا يعترف بالهرمية المهنية. ومن أهم أهدافه توفير فرص العمل لنساء المنطقة وتطوير مهاراتهن في الطبخ وتمريرها للأجيال القادمة من الرجال والنساء على حد السواء. المهم هو الرغبة في التعلم”.

يمكن إذن للزوار الاستمتاع بأجواء تجمع بين الطبيعة الخلابة وروح الفريق النسائي المُلهم، مما يجعل طبرقة جهة فريدة لعشاق السياحة البيئية والثقافية.
يجسد هذا الفضاء قيم التعاون النسوي كركيزة أساسية في بناء تجربة سياحية لا تُنسى، حيث تصنع النساء لحظات جمالية تتحدى الزمن وتعكس روح الجماعة والابتكار وتقاوم التهميش الاجتماعي وغياب فرص العمل.
بعد مرور السنوات الثلاثة الأولى للمشروع بسلام ونجاح، تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية في توثيق نجاح مشروع محافظ على البيئة والموروث المحلي للجهة، مشروع تغلب عليه روح التعاون بين النساء أصبح مزارا سياحيا مهما في مدينة طبرقة.
لكن الحرائق الأخيرة صيف 2023 أتت على الأخضر واليابس وأحرقت الغابة المحيطة بالمطعم وجزءا كبيرا منه كما قضت على المناظر الجميلة المحيطة بالمطعم لترسم مشهدا حزينا لما يمكن أن يؤدي له تغير المناخ والتطرف في درجات الحرارة، خاصة في الدول التي لم تتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة ولا تملك خططا واضحة واستراتيجيات مستقبلية لمجابهة تطرف المناخ الذي أصبح حقيقة ملموسة ومعاشة ومؤثرة بشكل مباشر على كل جوانب حياة السكان.

حدثتنا الخالة سعيدة وهي عاملة في المطعم مسؤولة عن تحضير الخبز: “في غفلة منا، كانت النار بعيدة وسيارات الحماية المدنية القليلة تتوجه بشكل متواصل إلى غابات ملولة من أجل إطفاء الحرائق… لقد تخيلت أننا بعيدون عن النار ولن تصل لنا ألسنة اللهب، لكن في بعض دقائق حاصرتنا النيران والتهمت الغابة المحيطة بنا وحرقت الأشجار والمطبخ وتمكنا من الهرب بصعوبة شديدة. لقد عشت أكثر من خمسة وخمسين سنة لم أشهد مثل هذا الجفاف أو شدة الحرائق التي عشتها هذا الصيف “
زرنا فريق عمل مطعم “pure nature” بعد أقل من شهر من اندلاع حرائق الصيف، وجدنا فريق العمل من النساء والرجال يحاولون تنظيف آثار الحرائق وترميم المطعم. وقد أكدت لنا أغلب الشهادات أن مشاهد الحرائق لم تمحى بعد من ذاكرتهم لكنهم عازمون على استئناف مشروعهم والبقاء في مكانهم على أطراف الغابة ومقاومة التغيرات المناخية بكل الأشكال الممكنة.
شهادات حول تأثير الحرائق على الغابة والنشاط الاقتصادي في المنطقة
لم تكن دلندة صاحبة مشروع “pure nature” فقط مستثمرة في مجال السياحة البيئية، أو مؤمنة بمنوال تشاركي في تسيير مؤسستها الصغرى، بل هي أيضا خريجة المعهد العالي لعلوم الغابات والمراعي بطبرقة (جامعة جندوبة) متحصلة على شهادة “تقني سامي في علوم وتقنيات الغابات والسياحة البيئية” وهو ما جعلها تمتلك رصيدا من المعارف التقنية والعلمية طبقته في تعاملها مع الغابة المجاورة لمشروعها.
حيث حافظ فضاء المشروع على حدود واضحة وفاصلة مع الغابة، وخلقت شبكة تجميع نفايات بمجهودات خاصة تجعل نظافة المكان مثالية من أجل عدم تلويث الغابة، كما استغلت في مشروعها النباتات الغابية والزيوت المحلية المستخرجة من الغابات وهو ما خلق عديد مواطن الشغل للعديد من نساء المنطقة.
لكن الحرائق الأخيرة دمرت جزءا مهما من النباتات والأشجار الغابية والأعشاب والحشائش الطبية التي كانت تعتبر مورد رزق جزء مهم من النساء الريفيات في المنطقة أو مشاريع التقطير الصغرى والمحلية في منطقتي طبرقة وعين دراهم.
قمنا بزيارة الغابة المجاورة للمطعم البيئي، رفقة دلندة والخالة سعيدة وبعض العاملات حيث رصدنا تضرر أشجار الفرنان والبلوط والحرق شبه الكلي لعدد من الحشائش والأعشاب الطبية، لكن ما يبعث الأمل حسب تصريح دلندة : “الأشجار المحلية مثل الفرنان يمكن أن تعيد النمو بسرعة، شرط وجود الأمطار وأيضا شجيرات القذُوم التي تعتمد عليها نساء المنطقة من أجل استخراج زيت القذُوم يمكن أن تنبت بسرعة، لكن الصنوبر الحلبي الذي تزرعه الدولة في صورة تعرضه للحرق لا يمكن أن يعيد النمو مرة أخرى، بل إنه يحتاج إلى القطع وإعادة الغراسة وأعتقد أن زرع أشجار مقاومة للتغيرات المناخية هو الحل الأمثل للحد من خطر الحرائق وعلى أجهزة الدولة تطوير الدراسات والتنسيق مع الباحثين وأصحاب المشاريع والمسؤولين المحليين من أجل حماية الغابة لما تمثله من أهمية بيئية وحياتية وثقافية للمنطقة ولكل تونس. يجب ألا ننسى أن غابات جندوبة تمثل نصف غابات تونس تقريبا واحتراقها يعني فقدان جزء مهم من الغطاء النباتي والحيوانات البرية في تونس.”
لم ينعكس الأثر السلبي للحرائق على أصحاب المشاريع السياحية، بل شمل العاملات الموسميات في تقطير الزيوت الغابية خاصة زيت الريحان وزيت القذُوم حيث حدثتنا الخالة فوزية وهي امرأة خمسينية تعودت منذ أكثر من عشرين سنة على تقطير الزيوت، حيث عبرت عن خيبة أملها كالتالي ” لم أستطع جمع حتى ربع الكمية التي كنت أجمعها السنوات الماضية، وأصبح العمل متعبا وغير مربح. لقد التهمت الحرائق أغلب شجيرات الريحان والقذُوم وهذا يهدد لا فقط عملي في تقطير الزيوت بل عمل أغلب النساء في كل قرى طبرقة. لقد وجدنا أجدادنا يجمعون ويُقطِرُون الزيوت فقمنا بالحفاظ على هذا النشاط، لكن للأسف الغابة أصبحت تحترق كل سنة وأنا متأكدة أن الأمور لو بقيت على حالها لن يبقى أحد في الأرياف الموجودة داخل الغابات وسوف تكون الجبال مهجورة من سكانها”.
لم يكن ما سرده علينا أنيس وهو راعي أغنام في أواخر العقد الرابع، بعيدا عن بقية الشهادات حيث أكد أن الحرائق أتت على أغلب المراعي، وأنه مضطر لبيع نصف قطيعه وإضافة إلى الكوارث الطبيعية حسب قوله بل غلاء الأعلاف وتملُص الدولة من كل أدوارها. حيث أكد أن غياب كاسرات الحرائق وتعبيد الطرقات التي تسهل وصول شاحنات الإطفاء وكذلك نقص العدد البشري لأعوان الغابات والحماية المدنية هو ما ساعد على انتشار الحرائق وعدم السيطرة عليها حيث أنه كان شاهد عيان طيلة أيام إطفاء الحرائق.
نلاحظ في مختلف الشهادات التأثير الواضح والملموس على مختلف أوجه حياة سكان القرى الجبلية في أرياف طبرقة وعين دراهم، وغياب الحلول والاستراتيجيات من قبل الدولة وهو ما فاقم تأثيرات التغيرات المناخية.
رغم ذلك شهدنا أيضا رغبة واضحة في المقاومة وخلق جسور التعاون بين السكان المحليين وقدرة على التكيف مع هذه المتغيرات، إلا أنه على الدولة التسريع في خلق حلول وتصورات حلول عاجلة للقرى الجبلية في طبرقة وعين دراهم وحماية الثروة الغابية والحيوانية في المنطقة.






 صورة عماد التريكي الممثل القانوني لمجمع الصيد البحري التقليدي بطبرقة. المكان الميناء التقليدي ملولة.
صورة عماد التريكي الممثل القانوني لمجمع الصيد البحري التقليدي بطبرقة. المكان الميناء التقليدي ملولة.